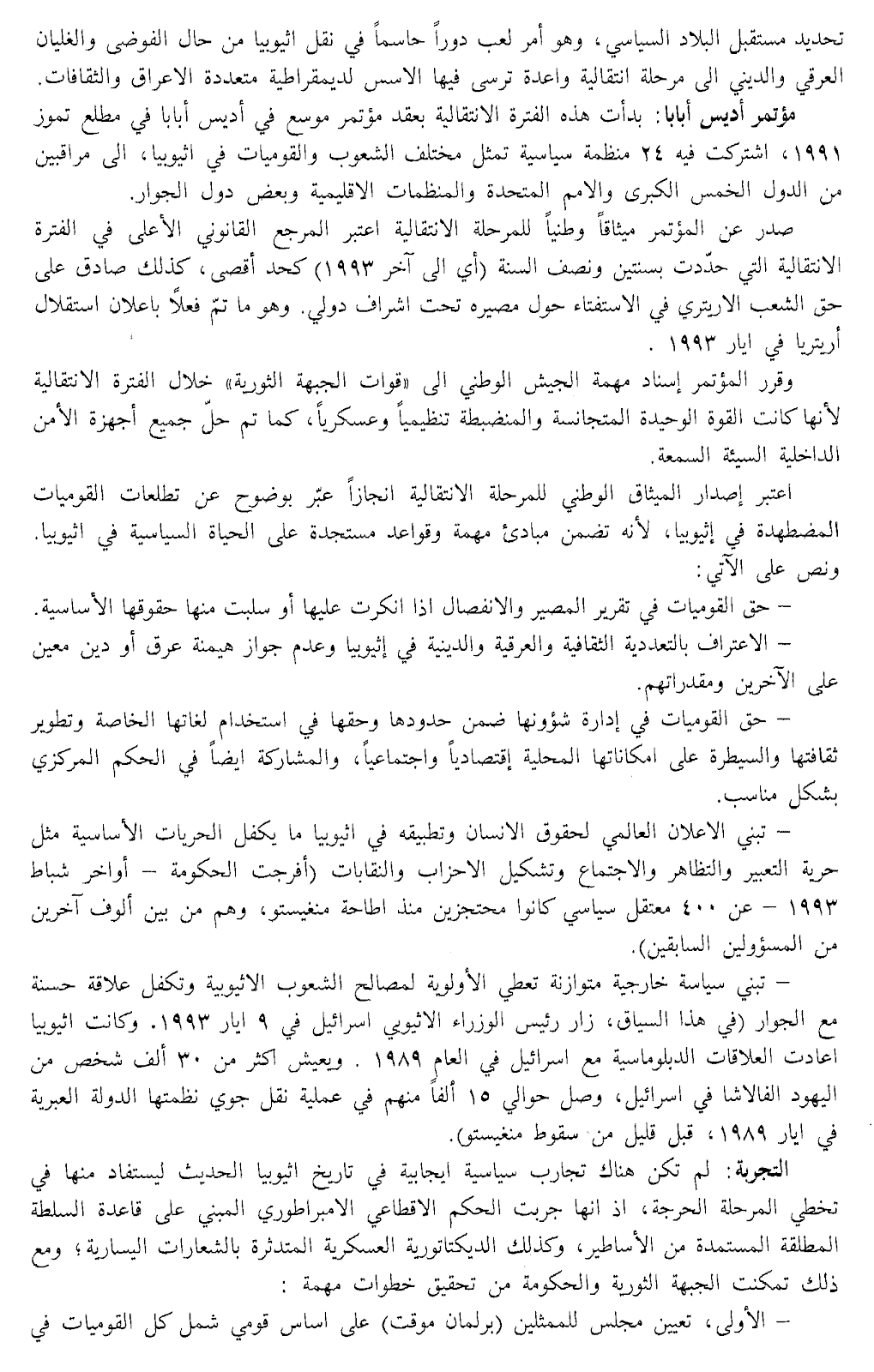خلال الألف الأول قبل الميلاد وصل الساميون إلى اثيوبيا وأسسوا مملكة أكسوم في هضابها المرتفعة بعد ان انتصروا على الحاميين الذين كانوا قد طردوا قبائل السود في مرحلة سابقة. وفي القرن الرابع الميلادي، وصل الى تلك الهضاب مبشران مسيحيان قادمان من سورية، فادخلا المسيحية في البلاد. ومنذ ذلك، قامت صلات وثيقة بين مسيحيي اثيوبيا والكنيسة المسيحية في مصر. ومع انتشار الاسلام في افريقيا السوداء طيلة القرن السابع، وجدت المملكة المسيحية في اثيوبيا نفسها معزولة عن محيطها. وكانت لهذه العزلة نتائج خطيرة بسبب ندرة المبادلات التجارية مع الخارج، وانقطاع العلاقات مع المدينات المزدهرة في شبه الجزيرة العربية. دامت تلك العزلة نحو الف سنة، قامت خلالها ممالك على انقاض ممالك. واشهرها مملكة الزاغويين (١١٧٠ – ١٢٧٠) الذين تركوا آثاراً هندسية (منها ١١ كنيسة منحوتة في الصخور في منطقة لاليلا) تنم عن مدينة مزدهرة. ومن الآثار المهمة الأخرى، خرائب تعود الى مملكة أكسوم القديمة، وتصور لبعض الملوك تعود الى القرن السابع عشر. يبدأ تاريخ اثيوبيا الحديث مع منليك الثاني الذي اصبح امبراطورًا العام ١٨٨٩. ويعتبر هذا الامبراطور نفسه سليل منليك الاول ابن سليمان الحكيم والملكة سبأ. وتمكن خليفته، منليك الثاني من القضاء على الثورات القبلية، وإقامة سلطة مركزية قوية. ورد الغزو الايطالي لبلاده (١٨٩٦)، وسمح للفرنسيين بانشاء خط حديد بين اديس ابابا وميناء جيبوتي. واخيرا، وضع أسس جيش عصري. واثر مرض أقعده، اعتزل منليك الحكم (۱۹۰۹)، وخلفه وريثه الامبراطور لياج الذي سبقه تحالف، في الحرب العالمية الاولى، مع الاتراك والألمان. اطيح به في نيسان ١٩١٦، وتوجت زوايترو، ابنة منليك الثاني، امبراطورة في حين أصبح قريبها تافاري ماكونن وصيًا على العرش. وبعد وفاة الامبراطورة في 3 نيسان ۱۹۳۰، طالب الوصي بالعرش وتوج امبراطورًا بإسم هايلي سيلاسي الاول. هايلي سيلاسي: قبل تتويجه وبعده، كان هايلي سيلاسي يعمل لاصدار تشريع يحظر العبودية في المجتمع الاثيوبي. فبع ابواب اثيوبيا امام النفوذ الغربي، واصدر دورات موجزة للخطاب وانشأ نظام تمثيلي من مجلسين: مجلس الشيوخ الذي يعين الامبراطور جميع اعضائه، ومجلس النواب الذي يختار زعماء المقاطعات والقبائل جميع اعضائه. واثر الغزو الايطالي لأثيوبيا (١٩٣٥ - ٣٦)، غادر هايلي سيلاسي البلاد وعاش في لندن حتى ١٩٤١، عندما تمكن الانكليز من طرد الايطاليين من اثيوبيا وتثبيت هايلي سيلاسي على العرش من جديد. وفي ١٩٥٢، ضمت اريتريا (التي كانت تحت السيطرة الايطالية منذ ١٨٨٩) الى اثيوبيا ضمن نظام فدرالي. وفي ١٩٥٥، اعلن الامبراطور تعديلات على الدستور القائم (أهمها انتخاب النواب من الشعب)، مع بقائه الحاكم الفعلي ومطلق الصلاحيات. في اواخر الخمسينيات، ضمت اثيوبيا أوغادين والحدود اليها. وفي ١٩٦٢، الغت النظام الفدرالي الذي يربط اريتريا بها واعتبرتها اقليماً من أقاليمها. وقد كانت هذه الأقاليم المضمومة اليها
بالقوة، أو بمناورة الدول، بمثابة قبائل مقوية في جسم اثيوبيا، وكانت حرب التحرير في اريتريا احد العوامل الرئيسية في إسقاط نظام هايلي سيلاسي، فضلاً عن فشل نظامه في تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية (زراعية على وجه الخصوص)، ومعالجة المجاعة التي اصابت البلاد ١٩٧٣ - ٧٧. منغيستو هايلي مريام و «الدرغ»: حقق العسكريون انقلابًا ناجحاً ضد الامبراطور هايلي سيلاسي، واتخذوا سلسلة إجراءات ضده انتهت بإقصائه رسميًا في ١٢ ايلول ١٩٧٤، وتشكيل مجلس عسكري حاكم «درغ». وبعد نحو ثلاثة اعوام، استولى منغيستو هايلي مريام (وكان على رأس المجلس العسكري) على السلطة، واقصى معارضيه واعدم عددًا منهم. في ١٩٧٨، تمكن الجيش الاثيوبي (بعد سلسلة هزائم كان مني بها) من رد الصوماليين عن إقليم أوغادين الذي كانت الصومال تطالب به. وقد وفر كل من الاتحاد السوفياتي وكوبا مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة للاثيوبيين مكنتهم من تحقيق هذا الانتصار. ومن ثم الانفراد باريتريا وشن هجوم كبير عليها في حزيران ١٩٧٩. وكانت سبقت هذه العمليات العسكرية زيارة منغيستو لموسكو (١٩٧٧)، وقيام الرئيس الكوبي فيدل كاسترو بجولته في القرن الافريقي، كما وقعت (تشرين الثاني ١٩٧٨) معاهدة تحالف مع الاتحاد السوفياتي. إفريقيا، تميزت علاقات اثيوبيا في اواخر السبعينات بإعلان مصر تضايقها من إقدام اثيوبيا على إقامة مشاريع على النيل الازرق وبدء استغلالها لمياهه. اما سياسة الوفاق والتضامن بين «الدرغ» والعديد من الحكومات الافريقية فقد ظهرت بعض ملامحها في الموقف المشترك المناهض لإسرائيل. في خريف ١٩٨٢، تجددت الاشتباكات بين الاثيوبيين (بمساعدتهم المعارضة الصومالية) والصوماليين الذين اعلنوا ان طيارين ألمان شرقيين وكوبيين اشتركوا في القتال الى جانب اثيوبيا. ولما لم تتمكن الصومال من الحصول على دعم مماثل من الغرب، دعا الرئيس الصومالي، سياد بري، إلى مفاوضات مباشرة لحل المشكلات العالقة بين البلدين. وفي ١٢ تشرين الاول ١٩٨٣، وفي اطار استمرار الجبهة العسكرية ساخنة بين اثيوبيا والصومال، قام منغيستو بزيارة عمل أخرى للاتحاد السوفياتي، تبودل فيها البحث في «التغييرات الاقتصادية العميقة» التي حققتها اثيوبيا.
مرحلة انتفاحية وإنجازاتها في ٢١ ايار ١٩٩١، هرب الرئيس الاثيوبي منغيستو هايلي مريام الى زيمبابوي كلاجئ سياسي بعد ان حاصرت قوات المعارضة (المتحالفة مع قوات اريتريا الداعمة للانفصال والاستقلال) اديس ابابا عقب سلسلة من الهزائم العسكرية منى بها الجيش الحكومي. وبدخول قوات «الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب اثيوبيا» العاصمة وسيطرتها على زمام الامور في عموم البلاد، دخلت اثيوبيا مرحلة مهمة في تاريخها المعاصر تميزت بحدوث تغيرات جذرية في توعية الحكم وفلسفته السياسية، وكذلك في نوعية وشكل العلاقة بين مختلف القوميات التي تتكون منها اثيوبيا ايضا. والانحسار السياسي التي تحقق للقوميات الاثيوبية بسقوط منغيستو وديكتاتوريته العسكرية، رفضت «الجبهة الشعبية، التفرد بالحكم، وأشركت القوى السياسية للقوميات الاثيوبية في
تحديد مستقبل البلاد السياسي، وهو امر لعب دوراً حاسماً في نقل اثيوبيا من حال الفوضى والغليان العرقي والديني الى مرحلة انتقالية واعدة ترسى فيها الاسس لديمقراطية متعددة الاحزاب سياسية واقتصادية (زراعية على وجه الخصوص)، ومعالجة المجاعة التي اصابت البلاد ١٩٧٣ - ٧٧. اشتركت فيه ٢٤ منظمة سياسية تمثل مختلف الشعوب والقوميات في اثيوبيا، الى مراقبين من الدول الخمس الكبرى والامم المتحدة والمنظمات الاقليمية وبعض دول الجوار. ومن المنتمر مساقا وعلنًا للمرحلة الانتقالية اعتبر المشروع القانوني الاعلى في الفترة الانتقالية التي حددت بسنتين ونصف السنة (اي الى اخر ۱۹۹۳) كحد اقصى، كذلك صادق على حق الشعب الارتيري في الاستفتاء حول مصيره تحت اشراف دولي، وهو ما تم فعلاً باعلان استقلال اريتريا في ايار ١٩٩٣. وقرر المؤتمر إسناد مهمة الجيش الوطني إلى «قوات الجبهة الثورية» خلال الفترة الانتقالية لأنها كانت القوة الوحيدة المتجانسة والمنضبطة تنظيميًا وعسكريًا، كما ان جميع أجهزة الأمن الداخلية السيئة السمعة. اعتبر إصدار الميثاق الوطني للمرحلة الانتقالية إنجازاً عبر بوضوح عن تطلعات القوميات المضطهدة في إثيوبيا، لأنه تضمن مبادئ مهمة وقواعد مستجدة على الحياة السياسية في إثيوبيا. ونص على الآتي:
حق القوميات في تقرير المصير والانفصال اذا انكرت عليها او ساولت منها حقوقها الاساسية.
الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية في إثيوبيا وعدم جواز هيمنة عرق او دين معين على الآخرين ومقدراتهم.
حق القوميات في إدارة شؤونها ضمن حدودها وحقها في استخدام لغاتها الخاصة وتطوير ثقافتها والسيطرة على إمكاناتها المحلية إقتصاديًا واجتماعيًا، والمشاركة ايضًا في الحكم المركزي بشكل مناسب.
تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في إثيوبيا ما يكفل الحريات الاساسية مثل حرية التعبير والتظاهر والاجتماع وتشكيل الاحزاب والنقابات (افرجت الحكومة - اواخر شباط ١٩٩٣ - ٤٠٠ معتقل سياسي كانوا محتجزين منذ اطاحة منغيستو، وهم من بين ألوف آخرين من المسؤولين السابقين).
تبني سياسة خارجية متوازنة تعطي الأولوية لمصالح الشعوب الاثيوبية وتكفل علاقة حسنة مع الجوار (في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الاسرائيلي في 9 ايار ١٩٩٣، وكانت اثيوبيا أعادت العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل في العام ١٩٨٩. ويعيش اكثر من 30 ألف شخص من اليهود الفالاشا في اسرائيل، وصل حوالي 15 الفًا منهم في عملية نقل جوي نظمتها الدولة العبرية في ايار ١٩٨٩ قبل قليل من سقوط منغيستو). التجربة: لم تكن هناك تجارب سياسية ايجابية في تاريخ إثيوبيا الحديث يستفاد منها في المرحلة الحرجة؛ اذ انها جربت الحكم الاقطاعي الامبراطوري المبني على قاعدة السلطة المطلقة المستمدة من الاساطير، وكذلك الديكتاتورية العسكرية المتدثرة بالشعارات اليسارية؛ ومع ذلك تمكنت الجبهة الثورية والحكومة من تحقيق خطوات مهمة:
الأولى، تعيين مجلس للممثلين (برلمان مؤقت) على اساس قومي شمل كل القوميات في الوزراء، إلا أن القيام بتعيينهم أهليًا: الثالث، ثم تأليف مجلس فترة انتقالية اتسمت بالهدوء وعززت مبدأ مشاركة الجميع في السلطة وعدم احتكارها من فئة معينة.
الثاني، تثبيت الأمن والاستقرار وفرض النظام والسيطرة على فلول الجيش الاثيوبي المنهار. وكان هذا التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة الانتقالية خلال العامين الماضيين (من انهيار نظام منغيستو في ايار ۱۹۹۱ حتى حزيران (۱۹۹۳) قياماً على تكوين اثيوبيا البالغ التعقيد بفعل تعدد الأعراق والأجناس.
الثالث، نقل السلطة الى القوميات لادارة شؤونها ضمن حدودها الجغرافية. ووفقاً لذلك تم تقسيم اثيوبيا الى ١٤ إقليماً على اساس قومي ولغوي على ان تتولى إدارة تلك الأقاليم مجالس تشريعية منتخبة بالاقتراع العام المباشر جرت تلك الانتخابات في النصف الثاني من ١٩٩٢). وفي البداية، اختارت المجالس التشريعية في كل من أقاليم الأورومو، التيغراي، العفر الصوماليين (أوغادين) لغاتها القومية كلغات رسمية. وجرى نقل السلطات التنفيذية الى سلطات الأقاليم ما عدا الدفاع والنقد والشؤون الخارجية والصناعات الاستراتيجية.
الرابع، تشكيل عديد من الأحزاب السياسية التي تتبنى برامج سياسية مختلفة في جميع أنحاء اثيوبيا؛ منها ما هو قومي محض ومنها ما يدعو الى تجاوز ذلك بإقامة تحالفات مشتركة. وظهر حزب سياسي يدعو الى عودة الملكية الى اثيوبيا وفق قالب دستوري جديد. وصدر (۱۹۹۲) قانون ينظم الصحافة والمطبوعات الف بالرقابة على الصحف. وتصدر في اثيوبيا الآن اواسط ١٩٩٣) أكثر من ٦٠ مطبوعة ما بين شهرية واسبوعية ويومية تملكها الاحزاب السياسية وشخصيات سياسية مستقلة، مما أعطى دفعة قوية للمارسة الديموقراطية في البلاد. فحتى صحف المعارضة الامهرية الصادرة في الولايات المتحدة تدخل البلاد بصورة شرعية وتوزع من دون تدخل من الحكومة على رغم أنها تعرض على النظام اللامركزي القائم وتناصبه العداء لما يعتقده انه يفقدها امتيازات تاريخية. وقد اعتقلت السلطات (٢٢) تموز (۱۹۹۳) زعيم «منظمة عموم شعب الامهرا» البروفسور اسبرت ولد بس، وباشر معه التحقيق في شأن أمر اصدره الى اعضاء منظمته لشن حرب على الحكومة الانتقالية الاثيوبية التي يرأسها ملس زيناوي. وكانت هذه المنظمة أنشئت في ايلول ١٩٩١، بعد استيلاء زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي، ملس زيناوي، على السلطة في أديس أبابا. ولا تشارك منظمة عموم شعب الامهرا» في الحكومة الانتقالية أو في البرلمان اللذين يضمان ممثلين عن غالبية القوميات الاثيوبية وعددها نحو ٨٠ قومية. وترفض المنظمة انفصال اريتريا عن اثيوبيا. وكان معظم قادة المنظمة مسؤولين رفيعي المستوى عملوا في عهدي الامبراطور هايلي سيلاسي والرئيس السابق منغيستو هايلي مريام، وهما أمهران. أوغادين: بعد أكثر من ثلاثين عاما من الحروب المتقطعة، خاضها الصوماليون في أوغادين طلباً للانفصال والاستقلال ضد الحكومات الاثيوبية المتعاقبة، في سياق الفترة الانتقالية وتنفيذاً لقرارات مؤتمر اديس ابابا (تموز (۱۹۹۱) الذي اشتركوا فيه الى جانب باقي القوميات في اثيوبيا، الى انتخاب (اذار (۱۹۹۳) رئيساً لسلطات الحكم الذاتي في اقليم أوغادين بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات المجلس الاشتراعي للحكم الذاتي. وبهذه الانتخابات، إضافة الى تشكيل الهيئة
التنفيذية (مجلس الوزراء)، اكتمل كيان الحكم الذاتي للأقليم، واعلان الزعماء فيه تخليهم عن مطلب الانفصال والاستقلال، وتوقيعهم لاتفاق في ما بينهم حول هذا الوضع في أديس أبابا (أواخر آذار ١٩٩٣) حيث أعلن الرئيس الأثيوبي، ملس زيناوي، على أثره أن «الصوماليين في اثيوبيا لا يسعون الى الاستقلال، ويتمتعون الآن بحكم ذاتي في اطار الدولة الاثيوبية» (راجع باب «مدن، ومعالم»).