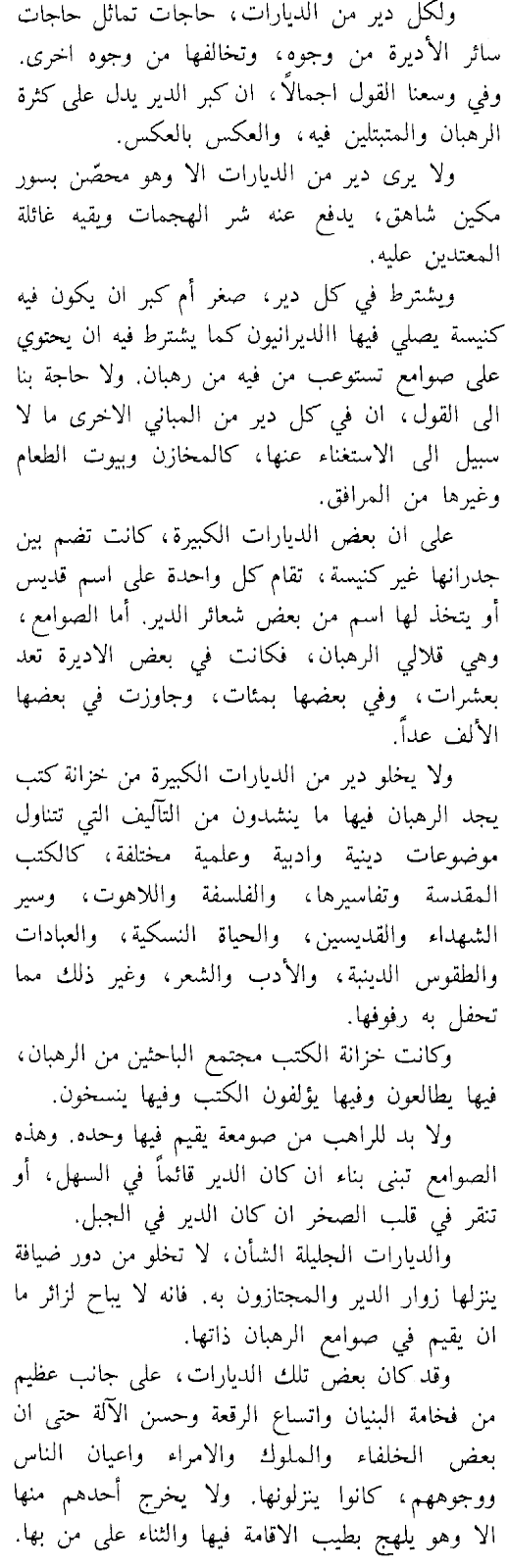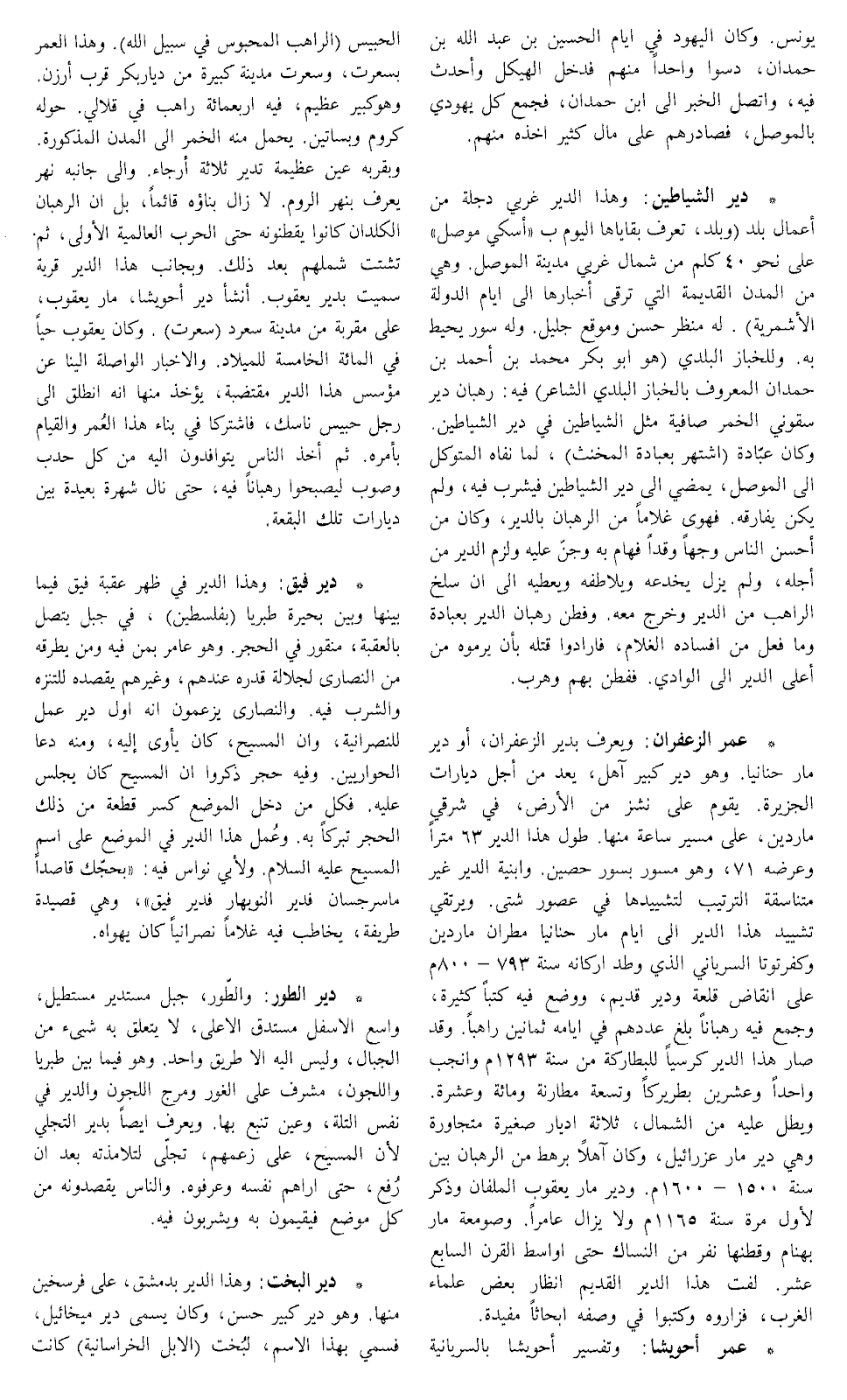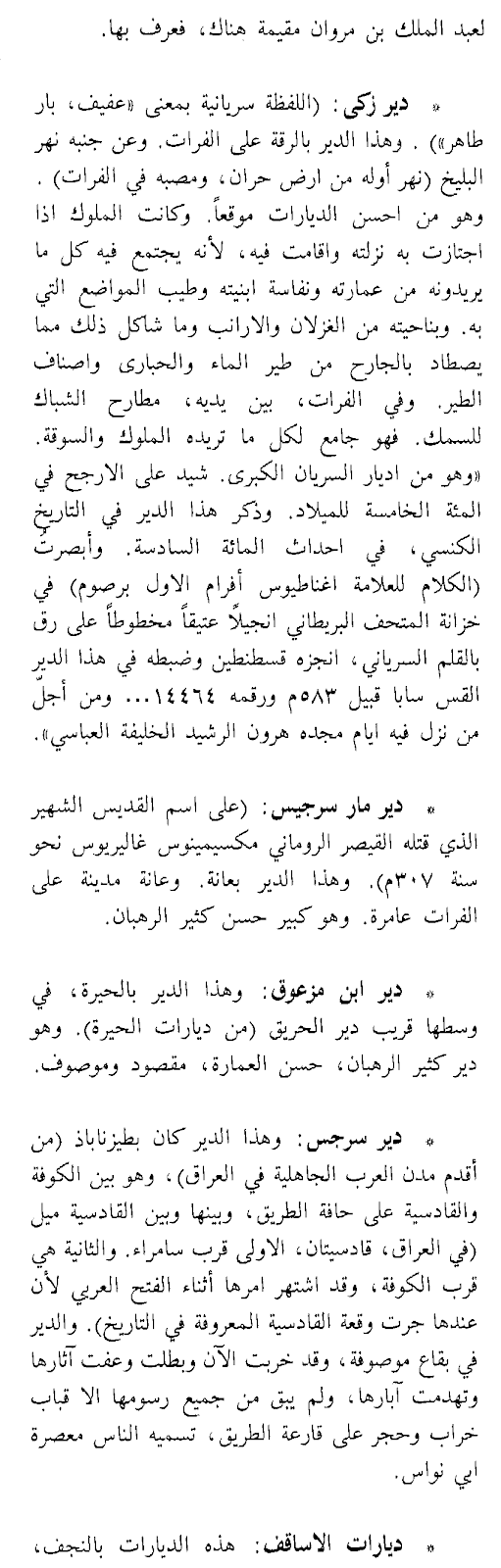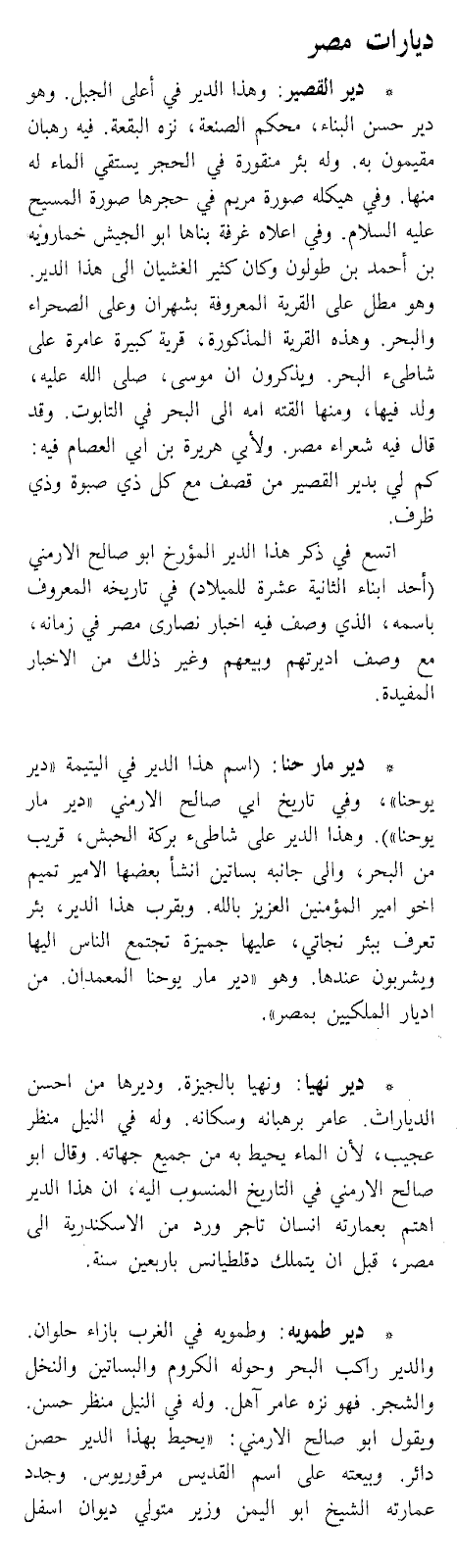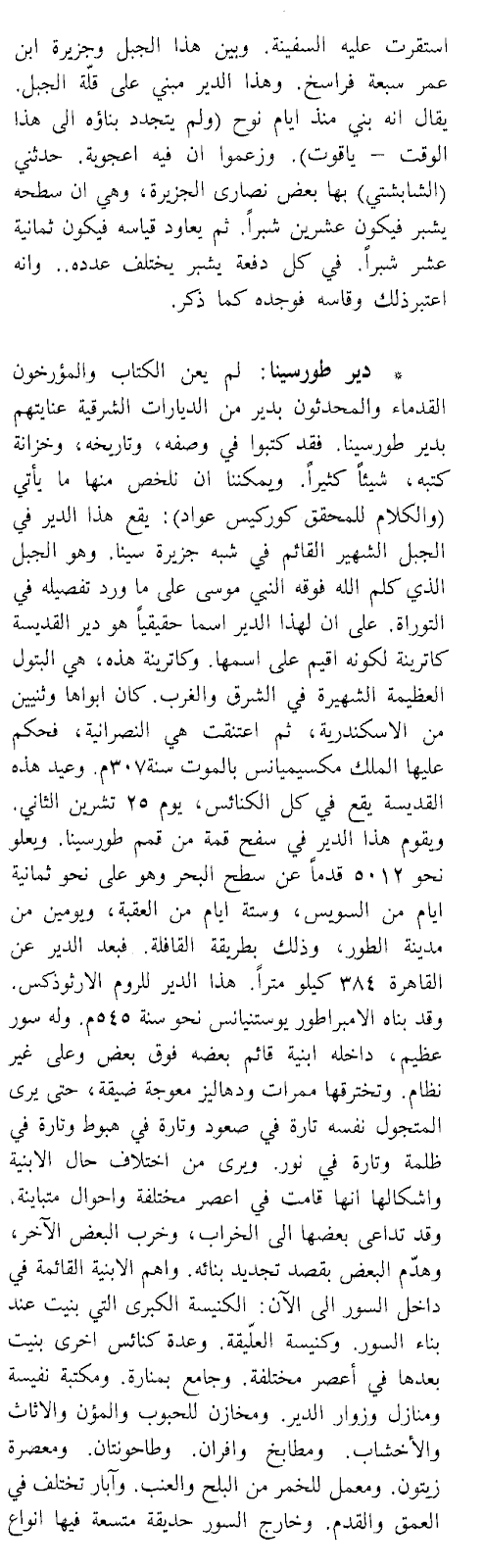ولكل دير من الديارات، حاجات تماثل حاجات سائر الأديرة من وجوه، وتخالفها من وجوه اخرى. وفي وسعنا القول اجمالاً، ان كبر الدير يدل على كثرة الرهبان والمتبتلين فيه، والعكس بالعكس. ولا يرى دير من الديارات الا وهو محصن بسور مكين شاهق، يدفع عنه شر الهجمات ويقيه غائلة المعتدين عليه. ويشترط في كل دير، صغر أم كبر ان يكون فيه كنيسة يصلي فيها الديرانيون كما يشترط فيه ان يحتوي على صوامع تستوعب من فيه من رهبان، ولا حاجة بنا الى القول، ان في كل دير من المباني الاخرى ما لا سبيل الى الاستغناء عنها، كالمخازن وبيوت الطعام وغيرها من المرافق. على ان بعض الديارات الكبيرة، كانت تضم بين جدرانها غير كنيسة، تمام كل واحدة على اسم قديس أو يتخذ لها اسم من بعض شعائر الدير، أما الصوامع، وهي قلالي الرهبان، فكانت في بعض الاديرة تعد بعشرات، وفي بعضها بمئات، وتجاوزت في بعضها الألف عدداً. ولا يخلو دير من الديارات الكبيرة من خزانة كتب يجد الرهبان فيها ما ينشدون من التآليف التي تتناول موضوعات دينية وأدبية وعلمية مختلفة، كالكتب المقدسة وتفاسيرها، والفلسفة واللاهوت، وسير الشهداء والقديسين، والحياة النسكية، والعبادات والطقوس الدينية، والأدب والشعر، وغير ذلك مما تحفل به رفوفها. وكانت خزانة الكتب مجتمع الباحثين من الرهبان، فيها يطالعون وفيها يؤلفون الكتب وفيها ينسخون. ولا بد للراهب من صومعة يقيم فيها وحده. وهذه الصوامع تبنى بناء ان كان الدير قائماً في السهل، أو تنقر في قلب الصخر ان كان الدير في الجبل. والديارات الجليلة الشأن، لا تخلو من دور ضيافة ينزلها زوار الدير والمجتازون به. فانه لا يباح لزائر ما ان يقيم في صوامع الرهبان ذاتها. وقد كان بعض تلك الديارات على جانب عظيم من فخامة البنيان واتساع الرقعة وحسن الدلأة حتى ان بعض الخلفاء والملوك والأمراء واعيان الناس ووجوههم، كانوا ينزلونها، ولا يخرج أحدهم منها الا وهو يلهج بطيب الاقامة فيها والثاء على من بها.
وان بعد موضع الدير عن مجاري المياه لجأ مؤسسوه الى استنباط الماء الذي يفي بأمور معيشتهم. فلا تقوم للدير قائمة ان فقد الماء. فنراهم يحفرون الآبار داخل الدير طلباً للماء. أو ينقرون الصهاريج في جوف الصخر ليجمع فيها ماء المطر. وان ركب الدير شواطىء الانهار، ألقيت حوله من البساتين والمروج والرياضين ما يهيج النظر ويشرح الخاطر.
دير درمالس: هذا الدير في رقة باب الشماسية، قرب الدار التي بناها الديلمي أحمد بن بويه، بباب الشماسية. وموقعه أحسن موقع. وهو يزه كثرة البساتين ويقربه أجمة قصب. وهو كبير، أهل برهبانه وقيصائه والمتبتلين فيه ... واعياد النصارى ببغداد، مقصومة على ديارات معروفة، منها اعياد الصوم ... ولأبي عبد الله بن حمدون النديم (كان استاذ أبي العباس ثعلب) فيه : يا دير درمالس ما احسنك ويا غزال الدير ما افتنك...
دير سمالو: وهذا الدير شرقي بغداد، بباب الشماسية، على نهر المهدي. وهناك أريحية للماء، وحوله بساتين واشجار ونخل. والموضع نزه، حسن العمارة، أهل به يطرقه، وبمن فيه من رهبانه. وعهد الفصح ببغداد، فيه منظر عجيب. لانه لا يبقى نصراني الا حضره وتقرب فيه، ولا احد من أهل التطرب واللهو من المسلمين الا قصده للتنزه فيه. وهو أحد متنزهات بغداد المشهورة، ومواطن القصف المذكورة. ولمحمد بن عبد الله الهاشمي فيه: وارت يوم في سمالو تم لي فيه السرور وغيبت احزانه ... (بني هذا الدير سنة ١٦٣ هـ (٧٧٩م) . وظل عامراً نحواً من خمسمائة سنة. وكان أهلاً برهبانه في ايام ياقوت الحموي. وذكر ابن عبد الحق ان هذا الدير "خرب، فلم يبق له اثر". فيكون خرابه قد حصل في نحو اواسط المائة السابعة للهجرة).
دير الثعالب: وهذا الدير ببغداد، بالجانب الغربي منها، بالموضع المعروف بباب الحديد. وأهل بغداد يقصدونه ويتنزهون فيه، ولا يكاد يخلو من قاصد ولا طارق. وله عيد لا يتخلف عنه أحد من النصارى والمسلمين. وباب الحديد أعمر موضع ببغداد ونزهه، لما فيه من البساتين والشجر والنخل والرياض،
ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد... وقد قالت الشعراء في الدير وباب الحديد وقيروانا (كذا في المخطوط: ترجمة لقديس اسمه قيرينا أو قيريانوس – المعروف عند الكتبة الغربيين باسم Cyprians) وقد قتل سنة ٢٥٨م... ولعل التسمية محرفة من «قيرونيا». وهي قديسة شهيرة قتلت نحو سنة ٣٠٩م).
دير الجاثليق: وهذا الدير يقرب من باب الحديد، وهو دير كبير، حسن، نزه، تحدق به البساتين والاشجار والرياحين. وهو يوازي دير الثعالب في النزهة والطيب وعمارة الموضع، لأنهما في بقعة واحدة. وهو مقصود مطروق. وفيه رهبانه وقيصائه. ولمحمد بن أبي أمية الكاتب فيه: تذكرت دير الجاثليق وفيه بهم ثم لي فيه السرور وأسعفا... (الجاثليق لفظ يوناني – Catholics – معناه «العمومي»، والمراد به الرئيس الديني الأعلى عند الكلدان النساطرة في أيام الملوك الساسانيين والخلفاء العباسيين ويقابله في وقتنا هذا «البطريرك»). وقد ذكر هذا الدير كثيرون من المؤرخين. وهناك دير ثاني عرف ايضاً بدير الجاثليق، وموضعه في شمال بغداد على الضفة الغربية. وهو على الحد بين آخر السواد وبين أول ارض تكريت. ولعل موضعه يرى في الاكثرية الحالية المعروفة اليوم بـ «أبو صخر». ودير الجاثليق هذا شهرة في تاريخ الاسلام، لنشوب معركة حامية في جواره سنة ٧١ هـ (٦٩٠م) بين عبد الملك بن مروان وبين مصعب بن الزبير. ويقول البلاذري ان عبد الملك بويع بدير الجاثليق، ودفنت جثة مصعب هناك.
دير مديان: وهذا الدير على نهر كرخايا ببغداد. وكرخايا نهر شق من المحول الكبير ويمر على العباسية، وبشق الكرخ، ويصب في دجلة، وكان قديماً عامراً والماء فيه جارياً، ثم انظم وانقطعت جريته بالشوق (جميع بشت = موضع الكسر من الشط) التي انفتقت في الفرات. وهو دير حسن، نزه. كان ديراً للنساطرة، ولغة هؤلاء السريانية. وياقوت الحموي ضبط اسم هذا الدير بكسر الميم، في حين انه ورد في مخطوطة الشابشتي بضمها. والذي عندنا ان هذا الضبط الثاني هو الوجه لتقارب لفظه من اللفظ السرياني المذكور.
دير أشموني: وأشموني، امرأة تبني الدير على اسمها، ودفنت فيه. وهو بقطر بقل غربي دجلة (قال
ياقوت ان بقطربول قرية بين بغداد وعكبرا، ينسب اليها الخمر. وما زالت متنزهأ للبطالين وحانة للخمارين. وقد أكثر الشعراء من ذكرها). وهناك أيضاً دير يسمى دير الجرجوتي وحوله بساتين ومزارع، زمن ضاق به دير أشموني، عدل اليه (لم نقف على دير بهذا الاسم. ولعله مصحف عن دير جرجس، أو دير جرجس). وما زال الى اليوم ذكر أشموني شائعاً بين ابناء كنائس المشرق، لا سيما بين السريان المشارقة والمغاربة. ففي العراق وغيره من الأقطار الشرقية، جملة كنائس عرفت باسم هذه القديسة: احداها في قره قوش (من أهم قرى شرقي الموصل وأعظمها شأنا. أهلها نصارى)، وفي قرية برطلي، كنيسة اخرى باسم أشموني، وهي عامرة. وفي باخعيقيا (من أجل قرى شرقي الموصل وانزهها. يسكنها اقوام من المسلمين والنصارى واليزيدية) كنيسة ثالثة مسماة باسمها ايضاً وهي عامرة يصلى بها يومياً. وهناك كنائس ومصليات عديدة في شمال العراق باسم أشموني. وهناك في غير العراق ديارات وكنائس باسم أشموني: فعند سور مدينة ماردين في جنوبها، دير مرت شموني المقابية، لا يزال قائماً. وقد كان في الإسكندرية بمصر، كنيسة للنساطرة على اسم القديسة مرت شموني وبسبعة أولادها ومعلمهم الكاهن اليعازر. وكان في مدينة بدليس (نواحي ارمينيا) كنيسة أخرى للنساطرة باسم هذه القديسة. وفي مدينة رأس العين، كنيسة أخرى كانت للنساطرة ايضاً، عرفت بهذا الاسم. كذلك في مدينة انطاكية، ومدينة ميزيات، وبلدة شدرا (في لبنان). ومن المراجع التاريخية، قديمها وحديثها، يستخلص أن أشموني كانت والدة الفتية المكابيين السبعة التي قتلت مع ابنائها واليعازر الشيخ. بعد أن كابدوا صنوف العذاب لانكارهم الطاعة على الملك انطيوخس أبيفانس السلوقي (١٧٦ – ١٦٤ ق.م).
دير سابور: وهذا الدير بيزوغي (من قرى بغداد، قرب المزرقة، بينها وبين بغداد نحو فرسخين) ، وهي بين المزرقة والصالحية في الجانب الغربي من دجلة. بيزوغي عامرة، نزهة، كثيرة البساتين والفواكه والكروم والحانات والخمارتين. والدير حسن، عام، لا يخلو من متنزه فيه ومتطرب اليه. ولعل (سابور) من (سابور). والا فقد تكون اللفظة سريانية بمعنى البشارة.
دير قوطا: وهذا الدير بالبردان على شاطىء دجلة. وبين البردان وبغداد بساتين متصلة ومنتزهات
متتابعة. والبردان من المواضع الحسنة، والبقاع النزهة والأماكن الموصوفة. وهذا الدير بها بجميع احوالها كثيرة، منها عمارة البلد، وكثرة فواكهه، ووجود جميع ما يحتاج اليه فيه؛ ومنها ان الشراب هناك مبذول، والحانات كثيرة. ولعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع (شاعر كان في ايام المعتصم) فيه: يا دير قوطا، لقد هيجت لي طرباً ازاح عن قلبي الاحزان والكربا.
دير جرجس: (مر، وتكتب: مار، لفظة سريانية معناها السيد وهي لقب يطلق على القديسين والاولياء والجثالقة والاساقفة: هذا الدير بالمزرقة. وهو احدى الديارات والمواضع المقصودة. والمتنزهون من أهل بغداد يخرجون اليه دائماً في السميريات لقربه وطيبه. وهو على شاطيء دجلة. والعروب (مفردها العربة: طواحين تقوم على سفن رواكد في النهر، كانت شائعة منذ ما قبل الاسلام في العراق والجزيرة وبعض ما جاورها من البلدان) بين يديه، والبساتين محدقة به، والحانات مجاورة له. وكل ما يحتاج اليه المتنزهون محاضر فيه.
دير باهيرا (لفظة سريانية «بيت شهرا» بمعنى محل السهر): وهذا الدير على شاطيء دجلة (بين سامراء وبغداد). وهو دير حسن، عامر... والمنحدرون من سر من رأى (سامراء) والصعدون اليها، ينزلونه. فمن جعله طريقاً، بات فيه وأقام به ان طاب له. ومن قصده، أقام الأيام في ألذ عيش واطيبه، وأحسن مكان وأنزهه.
دير بعيرا: هذا الدير بعكبرا (عكبرا: عرفها ياقوت بقوله : بليدة من نواحي دجيل. قرب صرين المياه، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ويقول البطاقة المحقق الاب حنا فياي، ان مدينة عكبرا، اسمها سابور الاول – ٢٤٣ – ٢٧٣م – واسكن فيها قوماً من الاسرى، وأصبحت كرسياً لأسقف نسطوري). ودير الخوات هو دير كبير عامر، يسكنه نساء مترهبات متبتلات فيه. وعيده الأحد الأول من الصوم، يجتمع اليه كل من ضرب منه من النصارى والمسلمين، فيعتد هؤلاء ويتنزه هؤلاء. وفي هذا العيد ليلة العاشوش، وهي ليلة تختلط النساء بالرجال، فلا يرد أحد يده عن شيء، ولا يرد احد احداً عن شيء. وهو من معادن الشراب (إشارة الى شراب عكبرا) في التيم، قال: «... ووضع لي يد كل واحد منهم طاس ذهب وزنه ألف
مثقال، مملوء شراباً قطرياً أو عكبراً).
دير العلق: والعلق، قرية على شاطىء دجلة، في الجانب الشرقي منها، وبين يديها ان دجلة موضع صعب، ضيق المجاز، كبير الحجارة، شديد الجرية، تجتاز فيه السفن بمشقة. وهذه المواضع تسمى الأبواب. واذا وافت السفن الى العلك، ارست بها، فلا يتهيأ لها الجواز الا بمهلا من أهلها يكترونه، فيمسك السكان وتتخلل بهم تلك المواضع، فلا يحطها حتى يتخلص منها. وهذا الدير راكب دجلة. وهو من أحسن الديارات موقعاً وأنزهها موضعاً.
دير العداري: وهذا الدير أسفل الحظيرة (قرية كبيرة كانت من اعمال بغداد من جهة تكريت)، على شاطيء دجلة. وهو من الديارات الحسنة، وبقعته من البقاع المستطابة. وانما سمي بدير العداري لان فيه جوار متبتلات عذارى، هن سكنته وقطانه. وكتب البطريك اغناطيوس افرام الأول برصوم الى المحقق كوركيس عواد بصدد هذا الدير يقول: «دير العداري كان ديراً للراهبات السريانيات في بغداد، في قطعة النصارى، حيث كانت بيعة مار توما للسريان. ذكره العلامة ابن العبري في احداث سنة ١٠٠٣م، وسماه دير الأخوات، وقال ان قوماً من السوقة حاولوا نهبه، ثم ولوا عنه هاربين لنبأ أتاهم ان خلقاً من الأوباش هلكوا في حريق نشب في البيعة المذكورة بفعلهم».
دير السوسي: وهذا الدير لطيف على شاطىء دجلة بفادسة (قرية كبيرة من نواحي دجيل، بين حربي بغداد، وكرخايا نهر شق من المحول الكبير ويمر على العباسية، وبشق الكرخ، ويصب في دجلة، وكان قديماً عامراً والماء فيه جارياً، ثم انظم وانقطعت جريته بالشوق (جميع بشت = موضع الكسر من الشط) التي انفتقت في الفرات. وهو دير حسن، نزه. كان ديراً للنساطرة، ولغة هؤلاء السريانية. وياقوت الحموي ضبط اسم هذا الدير بكسر الميم، في حين انه ورد في مخطوطة الشابشتي بضمها. والذي عندنا ان هذا الضبط الثاني هو الوجه لتقارب لفظه من اللفظ السرياني المذكور.
دير مر مار: صوابها «دير مر ماري» وبهذا الوجه ورد في معجم البلدان. وماري هذا من اقدم جثالقة –
بطارقة – المشارق. جعل مقامه في سلوقية، وبني كنيسة في دير فنى بالقرب من المدائن. وفيها توفي سنة ٨٨٢م. وهذا الدير يسر من رأى (سامراء) عند قنطرة وصيف. وهو دير عامر كثر الرهبان. حوله كروم وشجر. وهو من المواضع النزهة والبقاع الطيبة الحسنة. وللفضل بن العباس بن المأمون (من اولاد الخلفاء) فيه: بدير مر ماري اذ تسعى الصبوح به وتعمل الكأس فيه بالمشيات. وكان الخليفة المعتز يتردد على هذا الدير، واستمر على هذا النحو طول حياته.
دير مريخانا: وهذا الدير الى جانب تكريت، على دجلة. وهو كبير عامر كثير القلايات (مفردها القلاية: الصومعة ينفرد فيها الراهب) والرهبان، مطروق مقصود لا يخلو من مسافر ينزله. وله مزارع وغللات كثيرة وبساتين وكروم. وهو للنسطور اي انه للنساطرة = فرقة من النصارى عرفت باسم مؤسسها وقد صار بطريركاً على القسطنطينية سنة ٤٢٨م. ثم ذاع في آرائه الدينية عما هو ثابت لدى أئمة الكنيسة. وفي سنة ٤٣١م عقد مجمع ديني في أفسس حرم نسطور وتعاليمه وانزله عن كرسيه البطريكي. وقد انتشرت بدعته بين كثير من نصارى المشرق من بعده وما زالت بقاياها الى الآن بين الكلدان النساطرة. مات نسطور في صحراء ليبيا نحو ٤٤٠م. وعلى باب الدير صومعة عهدون الراهب، بنى الصومعة ونزلها فصارت تعرف به. وهو الآن المستولي على الدير والقيم به وبمن فيه. وقد بنى الى جانبه بناء ينزله المجتازون، فيقيم لهم الضيافة ويحسن لهم القرى. وعهدون الراهب رجل من الملكية (أو الملكانية: هم المسيحيون الشرقيون المنتمون الى الكرسي الانطاكي الخاضعون لملوك الروم، المعتقدون بتقرير المجمع الخلقيدوني، التابعون للكرسي الروماني).
دير صباعي: في دائرة المعارف الاسلامية: «دير سعابة»، وهذا غير صحيح. والصواب هو «دير صباعي»، بصاد مهملة مفتوحة، فباء مشددة. والمقصود به هنا القديس الشهيد «شمعون بر صباعي»، وبر صباعي لفظ سرياني بمعنى ابن الصباغين لان أهله كانوا يصبغون ثياب الملك، وباسمه عرف هذا الدير. كان شمعون بر صباعي جاثليق المشرق في المدائن، واصله من السوس. وقد ابتدأت جثلقته سنة ٣٧٩م. ثم أفادته سابور الثاني، الملك الساساني شديد
الاضطهاد ومر العذاب اكراهاً له على جحد النصرانية ليدين بالمجوسية. لكن شمعون لم يحيد عن دينه، فكان مصيره القتل مع جملة كبيرة من رفاقه، سنة ٣٤١م، في مدينة كرخ ليدان من أعمال الأهواز. وهذا الدير شرقي تكريت، مقابل لها، مشرف على دجلة. وهو نزه عامر. فيه خلق كثير من رهبانه وقسانه.
دير الأعلى: هذا الدير بالموصل (في اعلاها)، يطل على دجلة والعروب (العروب ضرب من الطواحين المائية). وهو دير عامر. فيه قلايات (صوامع) كثيرة لرهبانه. وله درجة منقورة في الجبل يفضي الى دجلة، وعليها يستقي الماء من دجلة. وتحت الدير عين كبيرة (تعرف اليوم بعين الكبريت) تصب الى دجلة، ولها وقت من السنة يقصدها الناس فيستحمون منها، ويذكرون انها تبرئ من الجرب والحكة وتنفع المقروعين (المتقعدين) والمرضى. والشعانين في هذا الدير حسن، يخرج اليه الناس فيقيمون فيه الأيام يشربون. ومن اجتاز بالموصل من الولاة نزله. وكان المأمون اجتاز بهذا الدير في خروجه الى دمشق، فأقام به اياماً. ووافى نزوله عيد الشعانين. اشتهر هذا الدير بكونه مركزاً خطيراً لطقوس الكنيسة الكلدانية. فقد ورد في كثير من كتب الطقوس، قول الناسخ «حسب نسخة الدير الأعلى». ومثل هذه العبارة تنبيء بأن هذا الدير كان يحرز خزانة كتب حافلة بالمؤلفات الطقسية وغير ذلك من المواضيع. وكان في هذا الدير مدرسة أطرى المؤرخون على تقدمها. وذهب الخوري سليمان صائغ إلى ان خراب هذا الدير كان في نحو أواسط القرن الثامن عشر للميلاد مستنداً في ذلك الى قصيدة الشاعر حسن عبد الباقي التي قالها سنة ١١٥٦ هـ (١٧٤٣م) في تجديد كنيسة الطاهرة للكلدان في أعلى الموصل. وقد تطرقت جملة من المصادر العربية الى ذكر هذا الدير، ومنها يستشف ما كان لهذا الدير من جليل المنزلة وبعد الصيت.
دير يونس بن متى: وهذا الدير ينسب الى يونس بن متى النبي. وهو في الجانب الشرقي من الموصل، بينه وبين دجلة فرسخان. وموضعه يعرف بنينوى، وينوي هي مدينة يونس عليه السلام. وأرضه كلها نوادر وشقاق. وله في ايام الربيع مظاهر حسن مونق، وهو مقصود. وتحت الدير عين تعرف بعين يونس. وكان اليهود في أيام الحسين بن عبد الله بن حمدان، دسوا واحدا منهم فدخل الهيكل وأحدث فيه، واتصل الخبر إلى ابن حمدان، فجمع كل يهودي بالموصل، فصادرهم على مال كثير أخذه منهم.
دير الشياطين: وهذا الدير غربي دجلة من أعمال بلد (ويلد) تعرف بقاياها اليوم بـ «أسكي موصل» على نحو ٤٠ كلم من شمال غربي مدينة الموصل، وهي من المدن القديمة التي ترقى أخبارها إلى أيام الدولة الآشورية. له منظر حسن وموقع جليل. وله سور يحيط به. وللخباز البلدي (هو أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بالخباز البلدي الشاعر) فيه: رهان دير ستقيني الخمر صافية مثل الشياطين في دير الشياطين. وكان عبادة (اشتهر بعبادة المخنث)، لما نفاه المتوكل إلى الموصل، يمضي إلى دير الشياطين فيشرب فيه، ولم يكن يفارقه. فيهوى غلاماً من الرهبان بالدير، وكان من أحسن الناس وجهاً وقد فها م به وجن وألزم الدير من أجله، ولم يزل يخدعه ويلاطفه ويعطيه إلى أن سلع الراهب من الدير وخرج معه. وقطن رهان الدير بعبادة وما فعل من الفساد فيه الغلام، فأرادوا قتله بأن يرموه من أعلى الدير إلى الوادي. فنفلت بهم وهرب.
دير الزعفران: ويعرف بدير الزعفران، أو دير مار حنايا، وهو دير كبير أهل، يعد من أجل ديارات الجزيرة. يقوم على نشر من الأرض، في شرقي ماردين، على مسير ساعة منها. طول هذا الدير ٦٣ متراً وعرضه ٧١، وهو مسور بسور حصين. وأبنية الدير غير متناسقة الترتيب لتشييدها في عصور شتى. ويرتقي تشييد هذا الدير إلى أيام مار حنايا مطران ماردين وكفرتوتا السرياني الذي ولد اركانه سنة ٧٧٣-٨٠٠م على انقاض قلعة ودير قديم، ووضع فيه كتباً كثيرة، وجمع فيه رهباناً بلغ عددهم في أيامه ثمانين راهباً. وقد صار هذا الدير كرسياً للبطاركة من سنة ١٢٩٣م وانجب واحداً وعشرين بطريركاً وتسعة مطارنة ومائة وعشرة. ويطل عليه من الشمال، ثلاثة اديار صغيرة متجاورة وهي دير مار عزراييل، ودير مار برهوم متجاور بين سنة ١٥٠٠ - ١٦٠٠م. ودير مار يعقوب السلمان وذكر لأول مرة سنة ١١٦٥م ولا يزال عامراً. وصومعة مار بهنام وقطنها نفر من النساك حتى اواسط القرن السابع عشر. لفقت هذا الدير القديم انظار بعض علماء الغرب، فزاروه وكتبوا في وصفه ابحاثاً مفيدة.
دير عمو حوشا: وتفسير احوشا بالسريانية
الحبيس (الراهب المحبوس في سبيل الله). وهذا المعم بسمرت، وسمرت مدينة كبيرة من دياربكر قرب أرزن. وهو كبير عظيم، فيه اربعمائة راهب في قلالي. حوله كروم وبساتين. يحمل منه الخمر الى المدن المذكورة. وبقربه عين عظيمة تدير ثلاثة أرجاء. وإلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم. لا زال بناؤه قائماً، بل ان الرهبان الكلدان كانوا يقطعونه حتى الحرب العالمية الأولى. ثم تشتت شملهم بعد ذلك. وبجانب هذا الدير قرية سميت بدير يعقوب. أنشأ دير أحوشا، مار يعقوب، على مقربة من مدينة سعرد (سعرت). وكان يعقوب حياً في المائة الخامسة للميلاد. والامتياز الواصلة الينا عن مؤسس هذا الدير مقتضبة، يؤخذ منها انه انطلق الى رجل حبيس ناسك، فاشتركا في بناء هذا المعم والقيام بأمره. ثم أتخذ الناس يوافدون اليه من كل حدب وصوب ليصبحوا رهباناً فيه، حتى نال شهرة بعيدة بين ديارات تلك البقعة.
دير فيق: وهذا الدير في ظهر عقبة فيق فيما بينها وبين بحيرة طبريا (بفلسطين)، في جبل يتصل بالعقبة، منقور في الحجر. وهو عامر بمن فيه ومن يطرقه من النصارى لجلالة قدره عندهم، وغيرهم يقصدونه للتنزه والشرب فيه. والنصارى يزعمون انه اول دير عمل للنصرانية، وان المسيح، كان يأوي إليه، ومنه دعا الحواريين. وفيه حجر ذكروا ان المسيح كان يجلس عليه. فكل من دخل الموضع كسر قطعة من ذلك الحجر تبركاً به. وحمل هذا الدير في الموضع على اسم المسيح عليه السلام. ولأي يونس فيه: «يحببك قاصداً مار سرجان قدير التوبهار فدير فيق»، وهي قصيدة طريقة، يخاطب فيه غلاماً نصرانياً كان يهواه.
دير الطور: والطور، جبل مستدير مستطيل، واسع الاسفل مستدق الاعلى، لا يتعلق به شيء من الجبال، وليس اليه الا طرق واحد. وهو فيما بين طبريا واللجون، مشرف على الغور ومرج اللجون والدير في نفس التلة، وعين تنبع بها. ويعرف ايضاً بدير التجلى لان المسيح، على زعمهم، تجلى لتلامذته بعد ان رفع، حتى اراهم نفسه وعرفوه. والناس يقصدونه من كل موضع فيقيمون به ويشربون فيه.
دير البحث: وهذا الدير بدمشق، على فرسخين منها. وهو دير كبير حسن، وكان يسمى دير ميخائيل، فسمي بهذا الاسم، لبحث (الابل الخراسانية) كانت
بظاهر الكوفة، وهو أول الحيرة. وهي قباب وقصور تسمى ديارات الاساقف. وبحضرتها نهر يعرف بالغدير، وعن يمينه قصر أبي الخصيب مولي ابي جعفر، وعن شماله السدير (من اشهر قصور الحيرة)، وبين ذلك الديارات.
قة الشقيق: (لفظة سريانية «شيقا» بمعنى الساكت والصامت). هي من الابنية القديمة بالحيرة، على طريق الحاج. وبإزائها قباب يقال لها الشكورة، جمعها للنصارى. فيخرجون يوم عيدهم من الشكورة الى القبة، في زي عليهم الصلبان، والشمامسة واللقان معهم يقدسون (على نغم واحد)، متفق في الالحان، ويتبعهم خلق كثير من متطيري المسلمين واهل البطالة الى ان يبلغوا قبة الشقيق، فيتقربون ويتعمدون، ثم يعودون بمثل تلك الحال. فهو منظر مليح.
دير هند: بنت هند (بنت النعمان بن المنذر) هذا الدير بالحيرة، وترهبت فيه وسكنته دهراً طويلاً، ثم عميت. وهذا الدير من أعظم ديارات الحيرة واعمرها. وهو بين الخندق ومحصراه بكير. في المراجع العربية القديمة ثلاثة مواضع عرفت بدير هند: الاول دير هند الصغير وهو المذكور. الثاني دير هند الكبرى، من ديارات الحيرة ايضاً. الثالث دير هند من قرى دمشق ذكره ياقوت. عن الاول، ذكر أبو الفرج الاصفهاني في أن هندا، «لما حبس كسرى النعمان الاصغر اباها، ومات في حبسه، ترهبت ولبست المسوح واقامت في ديرها مترهبة حتى مات، فدفنت فيه». وذكر ابن فضل الله العمري، ان بشر بن مروان «شق له (للدين) نهراً من الفرات. ولم يزل النهر يجري حتى خرب الدير».
دير زرارة: وهو دير حسن، بين جسر الكوفة وحمام أعين، ناحية عن الطريق على يمين الخارج من بغداد الى الكوفة. وهو موضع حسن كثير الحانات والشراب، عامر بمن يطرقه.
دير عمر بن يونان: وهذا المعمر بالانبار (مدينة كانت على الفرات في غربي بغداد). وهو عمر حسن كبير، كثير القلايات والرهبان. وعليه سور محكم البناء، فهو كالحصن له. ومن اجتاز بالانبار من الخلفاء، ومن دونهم ينزله مدة مقامه.
يؤخذ من المراجع التاريخية ان يونان مؤسس المعمر المعروف باسمه في الانبار، كان من جزيرة قبرس، من سلالة الملك قسطنطين. وقد تخرج في علم الطب والفلسفة. وذهب الى مصر واطرح العالم وزهد ولزم الطياعة، وتتلمذ على القديس أوجين. ثم قدم معه بلاد العراق وشيد في الانبار ديراً. وزار دير مار توما في الهند، ثم عاد الى ديره، وفيه توفي ودفن. لبث عمر مربونان قائماً زاهراً حتى أواسط المائة التاسعة للميلاد. فقد ذكر ماري بن سليمان ان المتوكل على الله الخليفة العباسي، أمر بهدم كنيسته فيما هدم من بيع واعمار. وقد كانت خلافة المتوكل من سنة ٢٣٢ الى ٢٤٧ هـ (٨٤٧ – ٨٦١ م) فيكون هذا المعمر، أو قل كنيسة، قد ظلت قائمة زهاء ٥٠٠ سنة.
دير قنى: (يعرف ايضاً بدير مار سابليج. والسليج لفظة سريانية بمعنى الرسول). وهذا الدير على ستة عشر فرسخاً من بغداد، بيته وبين دجلة ميل ونصف. فيه مائة قلاية لرهبانه والمتمثلين فيه، لكل راهب قلاية. وعليه سور عظيم يحيط به، وفي وسطه نهر جار. وعيده الذي يجتمع الناس اليه عيد الصليب: ١٤ أيلول.
في سيرة القديسين ان امرأة نبيلة تدعى قوني، أصيبت بالبرص، فشفاها ماري باعجوبة، فقابلت احسانه بأن وهبته كثيراً من ضياعها واراضيها. لكنه اقتصر من ذلك على بيت النار المجوسي، فشيد فيه ديراً هو دير قنى. ولما مات ماري دفن فيه. ومن ثم أصبح مدفناً لكثير من جثاثة الشرق. وانشأ ماري في الدير مدرسة كانت تدرس العربية والسريانية واليونانية واضاف العلوم والفنون. وكان فيها خزانة كتب حافلة تضم امهات التأليف التي كانت متداولة في ذلك العصر. وعن نهاية الدير، ما ذكره ياقوت والمتوفى سنة ٦٢٦هـ، (١١٢٨م): «واما الآن فلم يبق من هذا الدير غير سوره، وفيه رهبان صعاليك، وكانه خرب بخراب النهر وان».
دير عمر كسكر: وهو اسفل من واسط، في الجانب الشرقي منها بالقرية المعروفة ببرجومي. وفيه كرسي المطران. وهو عمر كبير عظيم حسن البناء محكم الصنعة. حوله قلايات كثيرة، كل قلاية منها لراهب.
ديارات مصر
دير القصير: وهذا الدير في أعلى الجبل. وهو دير حسن البناء، محكم الصنعة، نزه البقعة. فيه رهبان مقيمون به. وله بئر منقورة في الحجر يستقي الماء له منها. وفي هيكله صورة مريم في حجرها صورة المسيح عليه السلام. وفي اعلاه غرفة بناها ابو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وكان كثير الغشيان الى هذا الدير. وهو مطل على القرية المعروفة بشهران وعلى الصحراء والبحر. وهذه القرية المذكورة، قرية كبيرة عامرة على شاطيء البحر. ويذكرون ان موسى، صلى الله عليه، ولد فيها، ومنها القته امه الى البحر في التابوت. وقد قال فيه شعراء مصر. ولأبي هريرة بن ابي العصام فيه: كم لي بدير القصير من قصف مع كل ذي صبوة وذي ظرف.
اتسع في ذكر هذا الدير المؤرخ ابو صالح الارمني (أحد ابناء الثانية عشرة للميلاد) في تاريخه المعروف باسمه، الذي وصف فيه اخبار نصارى مصر في زمانه، مع وصف اديرتهم وبيعهم وغير ذلك من الاخبار المفيدة.
دير مار حنا: وهذا الدير في اليتيمة «دير يوحنا»، وفي تاريخ ابي صالح الارمني «دير مار يوحنا». وهذا الدير على شاطيء بركة الحبش، قريب من البحر، والى جانبه بساتين انشأ بعضها الأمير تميم اخو امير المؤمنين العزيز بالله. وبقرب هذا الدير، بئر تعرف ببئر نحاتي، عليها جميزة تجتمع الناس اليها ويشربون عندها. وهو «دير مار يوحنا المعمدان. من اديار الملكيين بمصر».
دير نهيا: ونهيا بالجيزة. وديرها من احسن الديارات. عامر برهبانه وسكانه. وله في التل منظر عجيب، لان الماء يحيط به من جميع جهاته. وقال ابو صالح الارمني في التاريخ المنسوب اليه، ان هذا الدير اهتم بعمارته انسان تاجر ورد من الاسكندرية الى مصر، قبل ان يتملك دقلطيانس باربعين سنة.
دير طمويه: وطمويه في الغرب بازاء حلوان. والدير راكب البحر وحوله الكروم والبساتين والنخل والشجر. فهو نزه عامر اهل. وله في التل منظر حسن. ويقول ابو صالح الارمني: «يحيط بهذا الدير حصن دائر. وبيعته على اسم القديس مرفوريوس. وجدد عمارته الشيخ ابو اليمن ويزر متولي ديوان اسفل
الارض (يزيد مصر السفلى)، والشيخ ابو منصور ولده، وذلك في الخلافة الآمرية (١١٠١ – ١١٣٠م) ووزارة الافضل شاهنشاه. وكان الافضل هذا ينزل فيه ويقيم به متنزهًا.
الديارات المعروفة بالعجائب
دير الخنافس: هو دير على هضبة غير بعيدة من قرية يريطي، في شرقي الموصل. يحمل اسم القديس دانيال الناسكي الذي بارح بعض أديار أمد (دياريكر) في صحبة القديس متى الناسكي سنة ٣٦٣م قاصداً بلاد نينوى. ولعله بني في العقد الاخير من المائة الرابعة أو الاول من المائة الخامسة. وانما أطلق عليه بعد ذلك هذا الاسم لظهور خنافس صغيرة في عيده الواقع ٢٠ من شهر تشرين الاول، مدة ثلاثة أيام، ثم تختفي في ما ذكر الخالدي وعنه نقل الشابشتي فياقوت. وكان هذا الدير عامراً أهلاً حتى غاية المائة الثالثة عشرة للميلاد (هذا ما كتبه العلامة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الاول برصوم في ٨ شباط ١٩٤١م). تقوم آخرية هذا الدير، في قبة «جبل العين الصفراء»، وله منظر عجيب لأنه يشرف على سهول نينوى كلها. وهذا الدير مربع، صغير الرقعة، لا تتجاوز مساحته مئتي متر مربع. وذكر البطريرك افرام رحماني، وقد زار هذا الدير سنة ١٨٩٦م، انه «تشاهد في بعض جدرانه المتهدمة كتابة (سريانية) سطرنجيلية يقرأ فيها اسم دانيال صاحبه».
دير الكلب: قال الشابشتي: «وهو بين الموصل وبلد. يعالج فيه من عضه كلب كلب. فمن عضه كلب كلب بادر اليه فيعالجوه منه برأ. ومن مضت له اربعون يوماً من العضة لم ينجع فيه العلاج». وتوسع ابن فضل الله العمري: «وهو قرب معلايا في سفح الجبال. والماء ينحدر عليه. وقلايه مبنية بعضها فوق المقدسي. (ومن العجائب) بارض الموصل: دير الكلب. يحمل اليه من عضه كلب مقور فيقيم عند رهبانه خمسين يوماً فيبرا بإذن الله تعالى».
دير القار وهو ليعقوبية، على اربع فراسخ من الموصل، في الجانب الغربي، من أعمال الحديقة، مشرف على دجلة. تحته عين قمر، وهي عين تقوم بها حار تصب في دجلة ويخرج منه البقير. «كان ديراً باسم مار زينا، واصله من نرسابادا (مدينة صغيرة كانت قريبة من تكريت). تتقصر هو واخته سارة. وتخبر خلقاً كثيراً وبنى بيعا واديارا وعلا صيته. ونسكت اخته وبني لها
دير. فمدة هذا الدير المعروفة كانت زهاء ستمائة سنة».
دير برقوما: (الاصح دير مر قوما، والبعض يقولون توما). وقوما اسم سرياني اطلق على ناسك من صنف العموديين كان يدعى شمعون من قديسي الكنيسة السريانية. واصله من ياجر مي (متصرفية كركوك في بلاد العراق). وقد نقل حبيب زيات في «الديارات النصرانية في الاسلام» خبراً يشير الى كارثة احاقت بهذا الدير في سنة ٤٩٩ هـ (١٠٥٧م) «عندما غزا جماعة من الغز التركمان جنود طغريلك السلجوقي هذا الدير. ففي تلك السنة (نقلاً عن صاحب مرآة الزمن) صعد عشرون رجلاً من الغز الى دير النصارى في ميافارقين. فيه اربعمائة راهب. فذبحوا منهم مائة وعشرين واشترى الباقون نفوسهم بست مكاكي ذهب وفضة».
دير باطا: وهذا الدير بالشرق (وفي معجم البلدان: بالسن، بين الموصل وتكريت وهيت). وهو دير حسن، عامر في ايام الربيع. ويسمى ايضاً دير الحمار. وشاهده يعرف بمر نيكس (لماه مرنيكس، بأكوس، ياخوس)، وهو ناء عن دجلة وعن المدينة. وزاد ياقوت: وفيه بئر تنفع من البهق، وفيه كرسي الاسقف.
دير الأب شمعون بنواحي السن للكلدان: وكان شمعون هذا (على لسان البطريرك افرام برصوم) ناسكاً كلدانياً عاش في اواخر القرن السادس حتى اواسط المائة السابعة.
دير العجاج: وهذا الدير بين تكريت وهيت، عامر كثير الرهبان. وخارجه عين ماء تصب الى بركة هناك. وفي البركة سمك اسود، وهو طيب عذب الطعم، وحوله مزارع وخضر تسقى من تلك العين. ومما كتبه البطريرك برصوم المذكور: «أصله دير عين جاج. بناه القديس العلامة مارنا مغريان الشرق والغرب المعروف بالتكريتي، نسبة الى كرسيه ... فأصبح هذا الدير ملجأ ووزراً ومأوى ومحط رحال لسائر أهل ما بين النهرين، وكل من يجتاز بها الى الكوفة (عراقيا)... ودام هذا الدير عامراً اكثر من ستمائة سنة. والارجح ان حروب التتر في اواسط المائة الثالثة عشرة للميلاد نكبته وامثاله نهباً وسلباً وتدميراً).
دير الجودي: والجودي هو الجبل الذي
تم استخراج النص من الصورة بنجاح:
استقرت عليه السفينة. وبين هذا الجبل وجزيرة ابن عمر سبعة فراسخ. وهذا الدير مبني على قلة الجبل. يقال انه بنى منذ ايام نوح (ولم يتجدد بناؤه الى هذا الوقت – ياقوت). وزعموا ان فيه اعجوبة، حدثني (الشابشتي) بها بعض نصارى الجزيرة، وهي ان سطحه يشمر فيكون عشرين شبراً. ثم يعاود قياسه فيكون ثمانية عشر شبراً. في كل دقيقة يشير بمختلف عدده. وانه اعتذر ذلك وقاسه فوجده كما ذكر.
دير طورسينا: لم يعن الكتاب والمؤرخون القدماء والمحدثون بدير من الديارات الشرقية عنايتهم بدير طورسينا. فقد كتبوا في وصفه، وتاريخه، وخزانة كتبه، شيئاً كثيراً. ويمكننا ان نلخص منها ما يأتي (والكلام للمحقق كوركيس عواد): يقع هذا الدير في الجبل الشهير القائم في شبه جزيرة سينا. وهو الجبل الذي كلم الله فوقه النبي موسى على ما ورد تفصيله في التوراة. على ان لهذا الدير اسماً حقيقياً هو دير القديسة كاترينة لكونه اقيم على اسمها. وكاترينة هذه، هي البتول العظيمة الشهيرة في الشرق والغرب. كان ابواها وثنيين من الاسكندرية، ثم اعتنقت هي النصرانية، فحكم عليها الملك مكسيميانس بالموت سنة ٣٠٧م. وعيد هذه القديسة يقع في كل الكنائس، يوم ٢٥ تشرين الثاني. ويقوم هذا الدير في سفح قمة من قمم طورسينا. ويعلو نحو ٥٠١٢ قدماً عن سطح البحر وهو على نحو ثمانية ايام من السويس، وستة ايام من العقبة، ويومين من مدينة الطور. وذلك بطريقة القافلة فبعد الدير عن القاهرة ٣٨٤ كيلو متراً. هذا الدير للروم الارثوذكس. وقد بناه الامبراطور يوستنيانس نحو سنة ٥٤٥م. وله سور عظيم، داخله ابنية قائم بعضه فوق بعض وعلى غير نظام. وتخترقها ممرات ودهاليز معوجة ضيقة، حتى يرى المتجول نفسه تارة في صعود وتارة في هبوط وتارة في ظلمة وتارة في نور. ويرى من اختلاف حال الابنية واشكالها انها قامت في اعصر مختلفة واحوال متباينة. وقد تداعى بعضها الى الخراب، وخرب البعض الآخر، وهدم البعض بقصد تجديد بنائه. واهم الابنية القائمة في داخل السور الى الآن: الكنيسة الكبرى التي بنيت عنه بناء السور. وكنيسة المليقة. وعدة كنائس اخرى بنيت بعدها في أعصر مختلفة. وجامع بمنارة. ومكتبة نفيسة ومنازل وزوار الدير ومخازن للحبوب والمؤن والآلات والاخشاب. ومطابخ وافران. وطاحونان. ومعصرة زيتون. ومعمل للخمر من البلع والعنب. وآبار تختلف في العمق والقدم. وخارج السور حديقة متسعة فيها انواع
الشجر والفاكهة. وفي خزانة كتب الدير نفائس المخطوطات النادرة، بالعربية واليونانية والقبطية والحبشية والسريانية، هذا الى قرامين تركية. وقد عني غير واحد من الباحثين والمستشرقين بالاطلاع على ما في هذه الخزانة من مخطوطات، وصنفوا في ذلك فهارس نافعة. وفي هذه الخزانة طائفة صالحة من المخطوطات، مكتوبة على الرق منذ عهد بعيد، ويرتقي تاريخ بعضها الى صدر النصرانية. وفيها كتب مطبوعة، أغلبها باليونانية والعربية.
بيعة أبي هور: (أو دير أبي هور كما في معجم البلدان). وهي بسرياقوس من اعمال مصر، عامرة كثيرة الرهبان، لها اعياد يقصدها الناس.
دير يحنس: هذا الدير بدمنهور من اعمال مصر. اذا كان يوم عيده، أرج شاهده من الدير في تابوت، فيسير التابوت على وجه الارض (يبدو ان المقصود احتفال ديني في يوم الجمعة العظيمة) لا يقدر احد ان يمسكه ولا يحبسه حتى يرد البحر فيغطس فيه ثم يرجع الى مكانه.
بيعة أترب: (في معجم البلدان: مارت مريم) وعيدها اليوم الحادي والعشرين من بونة (وهذا يقابله يوم الخامس عشر من آب). يذكرون ان حمامة بيضاء تجيثهم في ذلك العيد. فتدخل المذبح، لا يدرون من اين جاءت، ثم لا يرونها الى يوم مثله. زاد المقريزي على كلام الشابشتي هذا، قوله: «وقد تلاشى أمر هذا الدير، حتى لم يبق به الا ثلاثة من الرهبان، لكنهم يجتمعون في عيده. وهو على شاطىء النيل، قريب من بنها المصل».
والدراسات حول «الاديرة» في المنطقة، سواء اديرة القرون الاولى للمسيحية أو القرون التالية حتى اليوم، أكثر من ان تحصى. وقد وضع فيها كوركيس عواد، في القسم الثاني من تحقيقه المذكور، لائحة طويلة تناولت المراجع الموضوعة منذ بداية هذا القرن حتى أوائل الستينات. وبعد هذا التاريخ، تجد لوائح اخرى في كل دراسة حول الموضوع، وخصوصاً تلك المجلات التاريخية والتراثية والدينية، وبالاخص تلك الصادرة عن مؤسسات دينية مسيحية في لبنان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين ومصر.